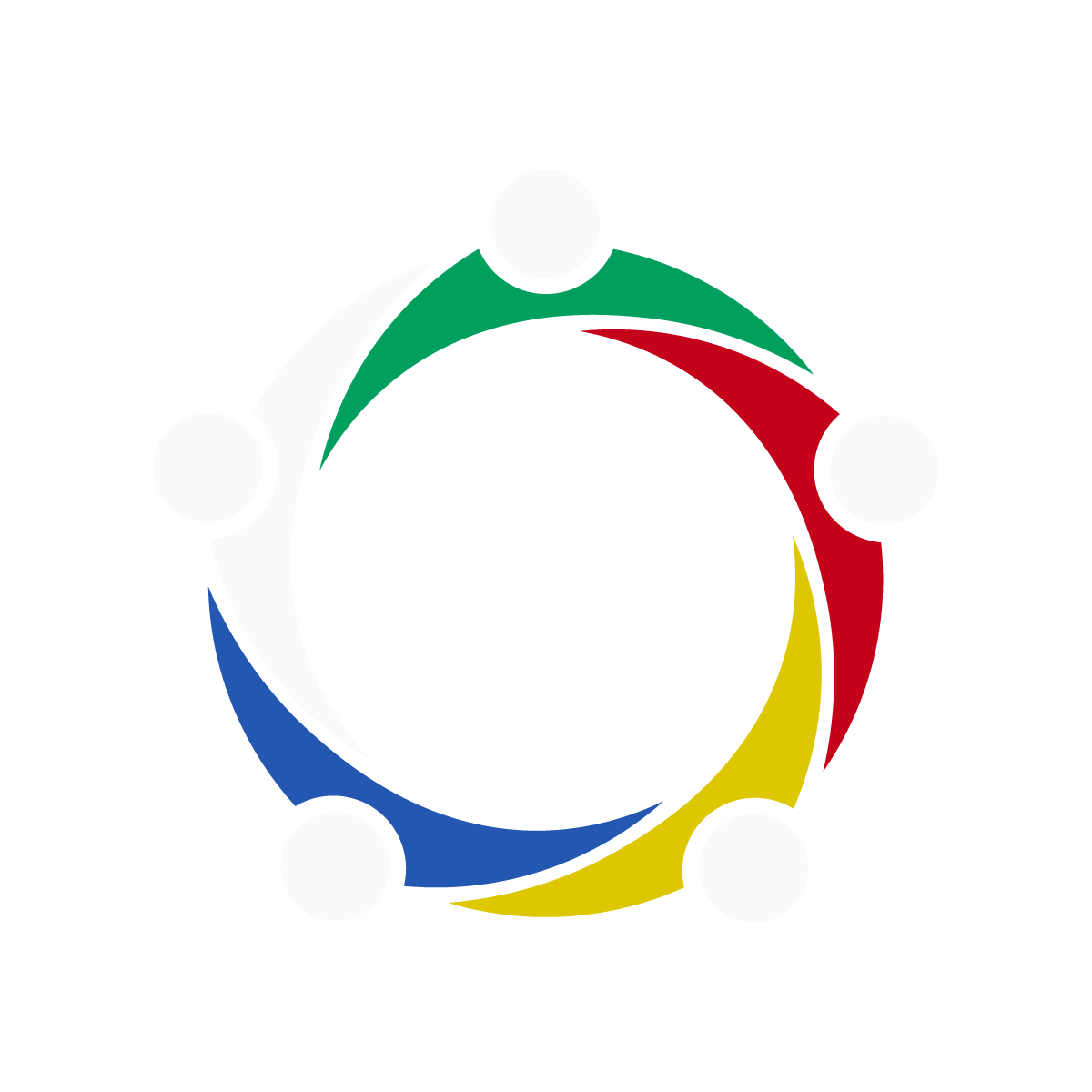وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ[ [سورة النور 40].
ان النفس الناطقة البشرية قبس من نور الله، جوهرة شفافة خالدة. إذا صقلناها بالخصال التوحيدية صفت وانجذبت حباً وهياماً إلى مبدعها كما ينجذب الحرف إلى معناه، والنهر إلى البحر المحيط، عندها يتعهدها الله بحسن تدبيرها فتحيَا فاضلة ساكنة مطمئنة وتصعد الدرجات.
ولا شيء يصقل النفس ويبلورها ويساعد على انجذاب الفرع إلى أصله أكثر من الصدق. فالصدق من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، والصدق قرار تنفيذي وموقف إيجابي يجب أن يقف على أرض صلبة كي لا تتزعزع أركانه ويهوى بنيانه، وهذه الأرض الصلبة هي التصديق. فالصدق بدايته تصديق ونتيجته محبة تصل العبد بالمعبود، فيشع النور الذي يضيء بين أجنحة العبد فيبدو كلمات على شفتيه وأعمالاً من خلال جوارحه.
إنه التصديق أولاً بان الإنسان هو غاية هذا الوجود وغرض الخالق سبحانه، وأن كل موجودات هذا الوجود ابتداءً بالمجرات وانتهاءً بالذرات والإلكترونات هي في خدمته من أجل تحقيق إنسانيته، ومعرفة باريه وطاعته. وما إنسانيته إلا تواصله مع خالقه عبر استشعاره في ذاته وفي كل ما يحيط به. إنها السعادة التامة يوم يستطيع الإنسان باعتقاده الصحيح أولاً وأعماله الخيّرة ثانياً أن يصقل جوهر نفسه الناطقة ليرى كل حقائق الوجود البديهية مطبوعة على مرآة بصيرتها. عندها يغدو العلم تذكراً كما قال أحد الحكماء، ويتطابق ما في جوهر النفس من الحقائق البديهية مع ما اكتسبه العقل من معرفة بالقوانين الكلية عبر ملاحظاته وتجاربه. عندها يتأكد الإنسان ان نفسه ليست إلا قبساً من نور الله، إنها خميرة الألوهة في هذه الحياة الدنيا. يتجلى الله لها إذا صفت وتشففت بالعلم والعمل المحقين، ويهجرها إذا أظلمت وتكثفت بأباطيل العلم وسوء العمل.
إنه التصديق بأن الوجود هو وجود غائي لا وجود عبثي، وأن كل سببٍ فيه يتبع أصله، لأن الله نظمه بناءً على قوانين أوجدها في طبيعة الموجودات. فلا شيء وليد الصدفة ولا شيء يخبط خبط عشواء، حتى الخوارق والمعجزات والعجائب ليست إلا ظواهر تخضع لقوانين عقلانية دقيقة لا زلنا نجهلها حتى الآن.
ولأن الخالق أبدع مخلوقاته بناءً على قوانين رتّبها بحكمته، كان لا بد للإنسان من أن يعلم ويصدق ان الطبيعة خيّرة بالكلية، والشر الذي يمارس على الأرض هو من تصرفات الإنسان خلافاً لقوانين الرُسُل والأنبية، لأنه بعناده واستكباره وفلسفته النفعية مُصِر ان يتجاهل قوانين الطبيعة وقوانين العقل ويتبع شهواته وجشعه وظلمة نفسه، فيمارس العدوان على نفسه بإهمال بذور الخير والحق والجمال والعدالة فيها، “فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره”. وعندما يثبت تصديق الإنسان بالرسالات السماوية والرسل والأولياء، يلمس بالعقل والتجربة ان التوحيد مستودع في جميع تلك الرسالات. فهو الروح الذي تحيا به الأنفس، ويتأكد ان الحق والخير والعدالة هو جوهر كل تلك الرسالات وغايتها وسدرة منتهاها، عندها يزول التعصب من قلب الإنسان وتزول السلبيات من عقله فينفتح إيجابياً على الجميع، عالماً علم اليقين أن المظاهر تتغير ويبقى الجوهر واحداً ينشد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيتصرف الإنسان ساعتئذٍ على مبدأ الحقيقة والعدالة الإلهية.
إنه الصدق الذي يلغي الازدواج بين ما يريده المرء بروحه وما يريده بجسده، فتنتفي الثنائية وينتفي التضادد بين الروح والجسد بالكلية حتى يصبح الجسد روحاً شفّافةً طائعةً لخالقها، متواصلة مع رُسُلِهِ وأنبيائِه، كما يتواصل الورد بأريجه والشعاع بشمسه. إنه الصدق الذي يحول الإنسان إلى عاشق أبدي، كلما اكتشف جزيرة من جزائر المرجان والياقوت في بحر الحب الإلهي يزداد فرحاً ويلتهب الشوق بين أجنحته لمزيد من الإبحار تفتيشاً عن جزيرة أخرى. إنه فرح التطور والارتقاء الدائمين، فالعشق علّمه ان الحركة الغائية هي جوهر هذا الوجود، وأن إنسان اللحم والدم الذي تشابك فيه المحدود واللامحدود، والوعي واللاوعي، والنسبي والمطلق، والكثيف واللطيف، سببه السفر الدائم في بحر حبه وشغفه وشوقه للتواصل مع أصله الذي لا تدركه العقول ولا تحيط به الخواط. فهو الأقرب إلينا من حبل الوريد، وهو البعيد عنا لأنه يحيط بنا ولا نحيط به، فنحن نسافر منه إليه في رحلة لا تنتهي. الشوق حاديها والحب مركبها والشغف إلى التواصل غايتها ومرادها.